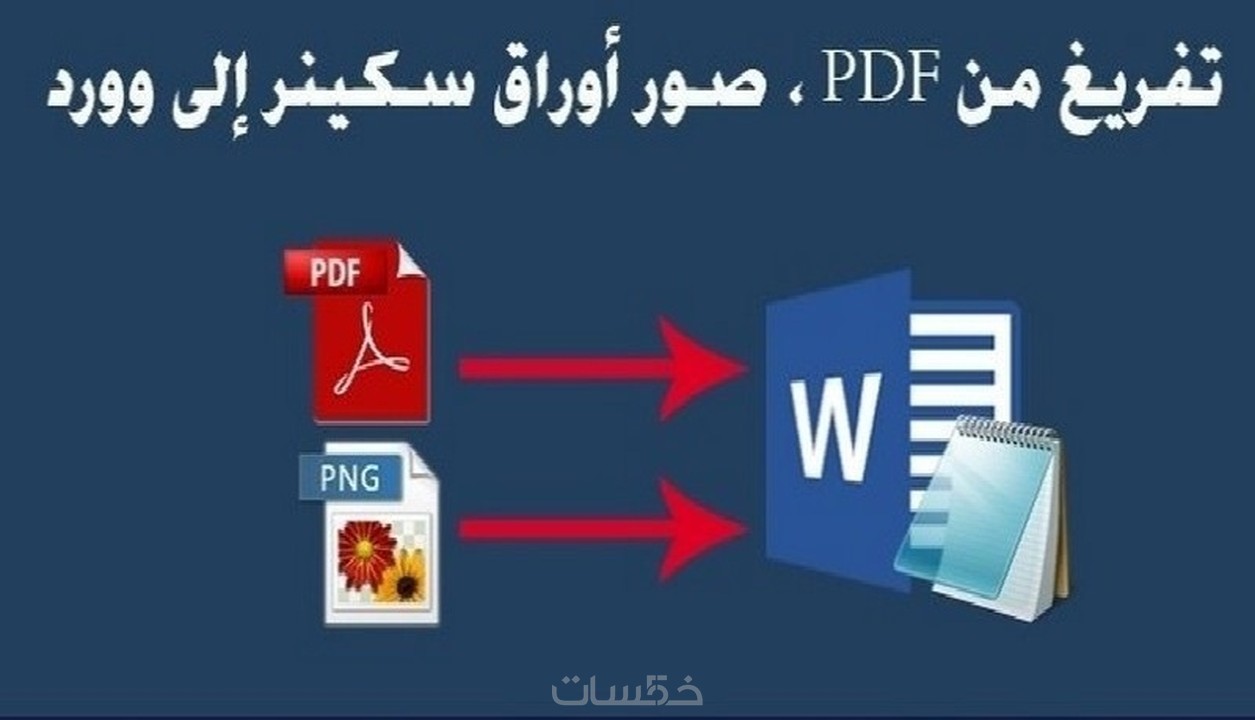منصور أبو كريم
الكاتب و الباحث السياسي
بعد أسبوع من العمل المتواصل في التحضير
والتنسيق والمتابعة مع الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش المفكر الفلسطيني ورئيس مجلس
أمناء جامعة الأزهر لعقد ندوة بعنوان قراءة في كتابه الموسوم " الانقسام الفلسطيني
وصناعة "دويلة غزة" لم نتمكن في مركز رؤية للدراسات والأبحاث من الحصول على
ترخيص لعقد الندوة من قبل الجهات المختصة في غزة، رغم تقديم الطلب لأكثر من مرة، الأمر
الذي دفعنا لإلغاء الندوة رغم أهمية الموضوع.
هذا الأمر دفعني لتقديم قراءة شخصية للكتاب
نظراً لأهمية الكتاب والأفكار التي حملها، والأحداث والتطورات الجارية في المشهد السياسي
الفلسطيني خاصة فيما يعرف "بصفقة القرن" التي ترتكز على قيام "دويلة
فلسطينية" في قطاع غزة، وهو ما يتوافق مع رؤية الكاتب في سياق متن الكتاب.
الكتاب من الحجم المتوسط، يحتوي على
200 صفحة تقريباً، به مقدمة وعشرة فصول، يتناول كل فصل قضية محددة من قضايا الانقسام:
كيف بدأ وكيف تطور حتى الوصول لمرحلة شبة الانفصال!فالكتاب يقدم شرحًا مفصلاً لمرحلة
مهمة من التاريخ السياسي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مرحلة اتسمت بالانقسام
وتداعياته الكبيرة والكثيرة على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرحلة
ألقت بتداعياتها على المشروع الوطني والحلم الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
تناول الفصل الأول من كتاب الانقسام الفلسطيني
وصناعة دويلة غزة، ماهية المشروع الوطني وعلاقته بالانقسام الفلسطيني؛ فقدم الدكتور
أبراش خلاله تعريفاً للمشروع الوطني الفلسطيني محدداته، حيث يرى أن المشروع الوطني،
هو مشروع معركة الاستقلال والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف، كأخر ما أتفق عليه الفلسطينيون في إعلان الاستقلال عام
1988، عندما أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين على أساس قرار 181،
وهو مشروع نقيض للمشروع الصهيوني، وهو ليس مُلكا لحزب أو جماعة سياسية معنية بل مشروع
مُلكا لكل من يؤمن به ويعمل على تحقيقه، ويربط بين المشروع الوطني واستقلالية القرار
السياسي فلا يوجد أي إمكانية لوجود مشروعاً وطنياً فلسطينياً بدون استقلال الفرار الوطني
الفلسطيني.
ويرى الكاتب أن الانقسام الفلسطيني هو النقيض
للمشروع الوطني الفلسطيني بالإضافة للمشروع الصهيوني، لذلك يقول " لأن المشروع
الوطني مشروع سلام ومشروع مقاومة فإن كل الأعداء الراغبين بضرب وتدمير المشروع الوطني
يشتغلون على جبهتين: استهداف مشروع السلام الفلسطيني القائم على التسوية العادلة، واستهداف
مشروع المقاومة بمفهومها الاستراتيجي الوطني، وهنا يمكن اعتبار كل نهج أو تفكير متعارض
ورافض للوحدة الوطنية يعتبر خروجاً على المشروع الوطني.
يوكد أن الانقسام مصطلح جديد أضيف لقاموس
المصطلحات السياسية الفلسطينية، وهو قاموس مكتظ بكل ما يعكس واقع الخلافات والصراعات
والأزمات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي حكمت القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى
الوقت الراهن. وهنا يحاول الكاتب أن يجول في الواقع الاجتماعي والسياسي الفلسطيني وتأثير
النكبة على وحدة الشعب الفلسطيني كون أن الكنبة فرضت واقع جوسياسي على الشعب الفلسطيني
أصبح الحديث معها على الوحدة السياسية والجغرافية أمرًا صعبا في ظل تشتت الشعب الفلسطيني
بين خمس مناطق مركزية هي الضفة الغربية وغزة، وداخل أراضي 48، الأردن وسورية لبنان،
هذا الواقع خلق ظروف سياسية واجتماعية أصبحت تلقي بتداعياتها على وحدة الشعب الفلسطيني
السياسية والجغرافية.
وتناول الفصل الثاني قضية الصراع على سلطة
تحت الاحتلال، أي سلطة أوسلو، (سلطة بدون سلطة) كون الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في كل
ما يتعلق بالقضايا الحياتية والسياسية والاقتصادية، وفي يده مفتاح السماح والمنع سواء
للأفراد أو البضائع.
فيرى الكاتب في هذا الفصل أن اتفاق أوسلو
جعل المشروع الوطني ينتقل من مشروع وطني (مستقل نسبيا) يمارس المقاومة ويرفع شعاراتها،
إلى مشروع وطني خاضع لشروط تسوية غير متوازنة أو تسوية مغامرة، ما أدى لحدوث تصدع في
الإجماع الوطني حول هذا المشروع عقب الانتقال من فكرة التحرير عبر البندقية إلى التحرير
عبر المفاوضات، في ظل غياب شبه تام لاستراتيجية وطنية، سواء فيما يتعلق بموضوع التسوية
في ظل تنكر إسرائيل لأسس عملية السلام وشروطها، أو في موضوع المقاومة المسلحة، ما جعل
المشروع الوطني الفلسطيني مرهون بعملية سلمية انحرفت عن مسارها عقب ربط هذا المشروع
بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين 242/338.
وينتقل الكتاب في هذا الفصل للحديث عن الانقسام
الأخر الذي نتج عن دخول حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني عقب دخولها الانتخابات
التشريعية عام 2006م، على برنامج سياسي مختلف تماماً عن برنامج المنظمة، وكيف عمق دخول
حركة حماس النظام السياسي الفلسطيني عقب فوزها بالانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة
العاشرة، وإعلانها عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ما سمح لإسرائيل بفرض
حصار مالي وسياسي على حكومة حماس والسلطة الفلسطينية، أزمة المشروع الوطني.
ويرى الكاتب أنه كان من المفترض أن تشكل
انتخابات 25 يناير 2006م حلاً لأزمة النظام السياسي والمشروع الوطني، فجاءت هذه الانتخابات
لتعميق الانقسام!، حيث فسرت حركة حماس فوزها في الانتخابات التشريعية وكأنه تفويض لها
بقيادة الشعب الفلسطيني بعيداً عن منظمة التحرير والشرعيات الفلسطينية الأخرى، ما يعطيها
الحق بتغير أسس ومرجعيات السلطة والنظام السياسي، متجاهلة أن مرجعية السلطة هي منظمة
التحرير الفلسطينية، وأن ما فازت به هو انتخابات لسلطة حكم ذاتي ناتجة عن اتفاقيات
موقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وهنا يحاول الكاتب أن يوضح أن مشكلة الانقسام
بدأت مع تبني حركة حماس مفهوم مختلف لفوزها بالانتخابات التشريعية، فاعتبرت أن هذا
الفوز يعني بالنسبة لها تفويض لقيادة الشعب الفلسطيني وليس مجرد نجاح في انتخابات لمجلس
تشريعي لسلطة حكم ذاتي تحت الاحتلال!
ويرى الكاتب أن حركة حماس أرادت أن توظف
آلية الديمقراطية عبر فوزها في الانتخابات التشريعية لتبرير انقلابها على السلطة الفلسطينية
كجزء من مخطط معد مسبقًا من قبل أطراف متعددة، وإن ما جرى يوم الرابع عشر يوليو
2007 عبر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة لم يكن حسما أو انقلاباً؛ بل
كان جزءً من مخطط دولي وإقليمي لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية لإقامة "دويلة
غزة".
وتناول الكتاب في الفصل الثالث خطة الانسحاب
الإسرائيلي من قطاع غزة، وهي الخطة التكتيكية التي مهدت الطريق لحركة حماس بالسيطرة
على قطاع غزة بدون مقاومة تذكر، لعلم إسرائيل بزيادة قوة حماس مقابل ضعف السلطة الفلسطينية
وأجهزتها الأمنية نظراً للاستهداف المباشر الذي كانت تتعرض له من قبل الجيش الإسرائيلي
خلال سنوات انتفاضة الأقصى الأولى.
ففي هذا الفصل يوضح الكاتب أن سيطرة حركة
حماس على قطاع غزة بالقوة جاء كجزء من مخطط استراتيجي إسرائيلي كان حاضرًا في الفكر
الاستراتيجي الإسرائيلي منذ بداية التسوية السياسية، في إشارة إلى الدراسة التي صدرت
عن أحد مراكز البحث الإسرائيلية عام 1989م، والتي تنبأت بحدوث صراع على السلطة بين
التيار الوطني والإسلامي على قطاع غزة، وسيطرة التيار على غزة بالقوة عقب طرد التيار
الوطني.
ويوضح الكاتب غياب استراتيجية وطنية للتعامل
مع خطة انسحاب شارون من قطاع غزة، وأن هذا الانسحاب لم يكن مفاجئ بل جاء في سياق خطة
استراتيجية إسرائيلية لمواجهة فشل مؤتمر كامب ديفيد عام 2000، وهو المؤتمر الذي رفض
فيه الفلسطينيون مقترحات الرئيس بل كلنتون التي كانت تنادي بانسحاب إسرائيل من 90%
من أراضي الضفة الغربية وجعل القدس منطقة مفتوحة.
ويوضح الكاتب كيف تم النظر إلى الانسحاب
الإسرائيلي بنوع من الاستخفاف بالقول إنه جاء نتيجة ضربات المقاومة الفلسطينية!، حيث
يقول في هذا السياق " عندما أعلن شارون عن خطته انبرت المعارضة لتقول إن شارون
يهرب من غزة تحت وقع ضربات المقاومة" فيؤكد أن البساطة في التعامل مع الحدث عن
قصد وبدون قصد سهل وقوع الفلسطينيين في فخ الانسحاب الإسرائيلي الذي جاء لخدمة الأهداف
الاستراتيجية الإسرائيلية بإحداث انفصال جوسياسي بين غزة والضفة الغربية عبر تسهيل
سيطرة حركة حماس على غزة بالقوة. ويبين الكاتب في هذا الفصل أيضا إشكالية حركة حماس
في الجمع بين السلطة والمقاومة، كون حركة حماس جاءت على برنامج سياسي لا يعترف بإسرائيل
والاتفاقيات الموقعة، بينما متطلبات الحكم تتطلب التعامل اليومي مع سلطات الاحتلال
الإسرائيلي.
وحاول الكتاب في الفصل الرابع معالجة حكومة حماس العاشرة، وإشكالية الجمع
بين المقاومة والسلطة في آن واحد، عبر عنه الكاتب بالقول أن مأزق حركة حماس في تلك
المرحلة تمثل في الانتقال من حركة جهادية ترفض المبدأ الأسس التي قامت عليها سلطة الحكم
الذاتي إلى حركة سياسية تترأس حكومة هذه السلطة!، وهو أيضا مأزق التوفيق بين المرجعية الأيديولوجية الدينية الأممية باعتبار
الحركة (حماس) امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، ومن جهة أخرى متطلبات العمل الوطني
النابعة من خصوصية الحالة الفلسطينية، ويوضح الكاتب في هذا السياق الخلل والتناقض في
الخطاب السياسي للحركة في تلك الفترة الذي حاول أن يبرر عدم تعاطي الحركة مع متطلبات
السلطة والقبول بالاتفاقيات الموقعة من خلال القول أن التنازلات السابقة التي قدمتها
الحكومات الفلسطينية والرئيس عرفات لم يحصلوا مقابلها على شيء!
وفي هذا الفصل يوضح الكاتب كيف تحولت الخلافات
السياسية بين البرامج المختلفة إلى صراع سياسي على السلطة، في ظل تعدد الشرعيات وتعدد
الرؤوس التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في ظل وجود حكومة تقودها
حركة حماس ورئاسة سلطة تقودها حركة فتح والرئيس عباس. ويوضح الكاتب كيف تحولت هذه الخلافات
والصراع على السلطة وصولاً لسيطرة حركة حماس على غزة بالقوة رغم التوصل لاتفاق مكة،
وهو الاتفاق الذي جاء برعاية العاهل السعودي الراحل الملك "عبد بن عبد العزيز"
لوقف حمام الدم الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويتناول الكتاب في الفصل الخامس المرحلة
الثانية من صناعة دويلة غزة، وهي المرحلة التي بدأت مع سيطرة حركة حماس على غزة بالقوة
المسلحة، رغم وجود اتفاق مكة الذي تم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة السيد إسماعيل
هنية، وهي الحكومة الحادية عشر في عمر السلطة الفلسطينية، فمع بداية هذه المرحلة دخل
النظام السياسي الفلسطيني والقضية الفلسطينية مرحلة انقسام الوطن بين شطرين، شطر تسيطر
عليه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وشطر تسيطر عليه حركة حماس. في هذا الفصل
يوضح الدكتور إبراش تجربته في تولي منصب وزير الثقافة الفلسطيني في حكومة الدكتور سلام
فياض الأولى والحكومة الفلسطينية الثانية عشر، وأسبابه لتولي المنصب التي جاءت للمساهمة
في الحفاظ على المشروع الوطني وأسباب ترك المنصب التي وضحها بالقول إنه لا يرغب أن
يكون جزء من مرحلة الانقسام وأدواتها المختلفة، خاصة في ظل حالة التجاذبات السجال السياسي
والإعلامي المتبادل.
ويتنقل الكاتب في الفصل السادس للحديث عن
قضية الساعة وهي قضية تحول قطاع غزة إلى "دويلة غزة" عبر الحصار والحروب
الإسرائيلية، ويوضح الكاتب في هذا الفصل أن الحصار الإسرائيلي خلق لدى حركة حماس
"كينونة غزة" فأصبح التركيز وتسليط الضوء على غزة ومأسي غزة وحصار غزة وحروب
غزة، ولجان تحقيق غزة، واجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع في غزة، حتي أصبحت غزة تسيطر
على المشهد الإعلامي في كبرى القنوات العربية والدولية، هذا الامر لم يكن أمراً عبثيًا
يقول الكاتب؛ بل جزءً من المخطط الإسرائيلي لجعل غزة هي فلسطين وفلسطين هي غزة؛ تمهيدًا
لطرح فكرة دولة غزة أو إمارة غزة. ويرى الكاتب أن هذا الأمر ساهمت فيه حركة حماس وقوى
إقليمية مختلفة بوعي وبدون بدون وعي. وهنايتساءل الكاتب عن الدعوات المتكررة لرفع الحصار
وتولي الزيارات المتكررة لغزة من قبل مسؤولين أوروبيين وأمريكان؟ أليست هذه الزيارات
تساهم في إنشاء (دويلة غزة)؟ ويؤكد الكاتب أن مشكلة غزة ليست إنسانية فقط، صحيح هناك
نقص في الغذاء الدواء والكساء، وأزمة في التعليم والمياه والبيوت المدمرة نتيجة استمرار
الاحتلال الإسرائيلي والانقسام، لكن التركيز على البعد الإنساني للأوضاع في غزة يحمل
أبعاد أخرى!
وهنا يرى الكاتب أن المشكلة في خطاب الحصار،
أنه يركز على حصار غزة والأوضاع الإنسانية في غزة ويتجاهل الوضع في الضفة الغربية!،
يتجاهل الاستيطان والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهويد القدس، ويرى
الكاتب أن هذا التهويل المتعمد للحصار الإسرائيلي ومعاناة غزة وتسليط الضوء على معاناة
غزة، التيساهمت فيها قوى سياسية إسلامية وقنوات إعلامية محسوبة على التيار الإسلامي،
حتى أصبحت غزة أكثر قداسة من القدس في عيون التيار الإسلامي، فلا نسمع عن حملات شعبية
عربية وإسلامية لوقف الاستيطان في الضفة أو تهويد القدس، حتى حركة حماس لا تقوم بأي
عمل مقاوم مسلح أو شعبي في الضفة الغربية، وكأنها اكتفت من الوطن بغزة!
يرى الكاتب ان حصار غزة تحول "لحائط
مبكي" جديد، ومادة دسمة إعلامية لأحزاب وأنظمة سياسية لم يعد يعنها أمر فلسطين
ولا الضحايا بحد ذاتهم بل توظيف المشهد والخطاب الدرامي للحصار لخدمة مشاريعها السياسية
واجندتها الخاصة، فتحت عنوان رفع الحصار عن غزة يتم إعادة صياغة القضية الفلسطينية
والانقلاب على أصولها الأولى ونكران تاريخ طويل من النضال الوطني والقومي.
يوكد الكاتب أن الحصار جزئية من استراتيجية
إسرائيلية أكثر شمولاً وافتعال مشكلة الحصار هدفه ابعاد الأنظار عن جوهر القضية الفلسطينية
في الضفة والقدس وعودة اللاجئين، فلا شك أن الحصار يدمر مقومات الحياة الكريمة للبشر
ويدمر ممكنات البنية التحتية للقطاع والسكان، لذلك المطلوب رفع الحصار وليس تحوله
"لحائط مبكى" جديد لخدمة أجندات حزبية وإقليمية يقول الدكتور أبراش!
وهنا يرى الكاتب أن المشكلة في التعامل
مع الحصار بعيدًا عن السياق الوطني العام، يجعل من قضيةرفع الحصار والأزمة الإنسانية
في غزة مدخلاً وأداة تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية، فبدلًا من أن يتحول الضحايا (ضحايا
الحصار والحروب الإسرائيلية) لقوة ضمن المشروع الوطني الفلسطيني يصبحوا ورقة ابتزاز
يوظفها العدو لاستكمال مشروعه الاستراتيجي في السيطرة التامة على الضفة والقدس وتدمير
المشروع الوطني التحرري، وتحويل قطاع غزة لساحة صراع فلسطيني/ فلسطيني يخوض فيه الفلسطينيون
الحرب بالوكالة عن أصحاب أجندات إقليمية دولية غير وطنية.
بشكل عام الكتاب يعالج أزمة المشروع الوطني
الفلسطيني ومأزق الانقسام، وتردي الوضع الداخلي الفلسطيني منذ التوقيع على اتفاق أوسلو
مروراً بالتحولات التي شهدها الحقل السياسي الفلسطيني عقب تحول مسار الثورة الفلسطينية
من الكفاح المسلح للتسوية السياسية، انتهاءً بسيطرة حركة حماس على غزة.
ويقدم الكتاب شرحاً مفصلاً للأحداث والتطورات
التي حدثت في المشهد السياسي الفلسطيني خلال الفترة الممتدة منذ التوقيع على اتفاق
أوسلو وحتى الوقت الراهن مع تحليل للمحطات الرئيسية التي وقعت خلال تلك الفترة، برؤية
الكاتب كونه شاهد على العصر، وأحد شهود العيان على الأحداث.
الكتاب هو بمثابة تاريخ الحركة الوطنية
الفلسطينية خلال العشرين عام الماضية، بما تضمنه من أحداث ووقائع وتطورات، هو بمثابة
صرخة وجرس إنذار في مواجهة "دويلة غزة" التي يراد منها أن تكون بديلة عن
فلسطين.
ما يود قوله الكاتب والكتاب بصورة مباشرة
وغير مباشرة؛ أن غزة ليست فلسطين، وفلسطين ليست غزة، وإن ما يحدث من عملية تحويل الحصار
لحائط مبكى جديد يساهم في إنشاء "دويلة" غزة التي تتوافق مع الرؤية الإسرائيلية
والأمريكية لحال المسألة الفلسطينية، فلا تكونوا جزء من الرؤية الإسرائيلية والأمريكية.